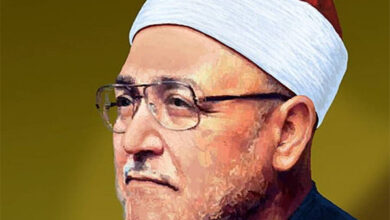رسالة د. محمد هيثم الخياط إلى مجمع اللغة العربية بالقاهرة
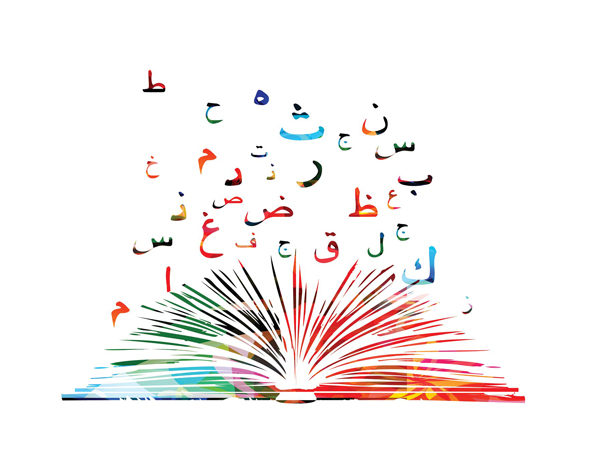
سَبَقَ لي أن أشرتُ في هذا المجمع الموقّر إلى أننا أصبحنا – في مطالع القرن الحادي والعشرين – نُوَاجَهُ بسيل مُنْهَمِر من المفاهيم الجديدة والمكتشفات الجديدة والمخترعات الجديدة، ولدينا أجيال كاملة عاجزة عن فهم أي لغة أجنبية، جرَّاءَ إخفاق طويل الأمد في السياسة التعليمية. هذه الأجيال لن تستطيع أن تكتسب من الثقافة العلمية العالمية اكتساباً صحيحاً كاملاً إلا ما يُنقل إليها معرَّباً، أي إن التعريب هو نافذتها الوحيدة للإطلال على العالم.
وذكرتُ أننا في ترجمة المصطلحات المبتكرة التي تعبّر عن هذه المفاهيم والمكتشفات والمخترعات، نَكِلُها بحكم الواقع إلى فئتين اثنتين: فئة الإعلاميِّين وفئة التعليميِّين. والإعلاميون العاملون في الإعلام المقروء والمسموع والمرئي، هم أوّل من يتلقّف هذه الألفاظ، فيستفرغون طاقتهم ويبذل قصارى جهدهم في نحت المصطلح العربي المناسب. وذلك جهدٌ محمود مشكور. وثـَمَّة طائفة أخرى من الألفاظ لا داعي للسرعة في ترجمتها، وإنما يقوم بنحت مقابلاتها العاملون في التعليم على اختلاف مراتبه ولاسيَّما التعليم العالي.
****
أما مجامع اللغة العربية فليس من شأنها أن تضع المصطلحات ولا في مكنتها أن تفعل ذلك، ولكنها تضفي الشرعية على المصطلح بما تمثِّله من سلطان جماعي، وتُرسي قواعد وضع المصطلح بما يمكّن الإعلاميِّين والتعليميِّين من حُسْن التصرُّف في صوغ هذه الألفاظ المستحدَثة.
وقد كان الخليل بن أحمد رحمه الله، أوَّلَ مَنْ نبَّهَ على أنَّ لهذه اللغة الشريفة أصلاً كان عليه بنيانها. وذلك وجهٌ من أهمِّ أوجُهِ عبقرية الخليل، وبُعْدٌ رائع من أبعاد ذهنيَّته الرياضية الفذَّة، تلك الأبعادُ التي لا نكاد نعرف لها مُجْتَمِعَةً نظيراً في عباقرة الأمم جميعاً. وقد كان للخليل فضلُ ابتكار هذا التصوُّر الذي تقيَّل ظلالَه علماء العربية مِنْ بعده. ويُخيَّل إليَّ أنه بفضل ذِهْنِهِ الرياضي الفَريد، قد قام بعملية استيفاءٍ راجعٍ مُدْهِشَة، تابَعَهُ فيها سيبويه ومن جاء بعده، وتوصَّلوا منها إلى صرح جميل كأنه ممرَّد من قوارير، لا ترى فيه عِوَجــاً ولا أمْتــاً، ولا تُحِسُّ فيه شذوذاً ولا خَلَلاً.
وهذا التصوُّر أشار إليه ابن جني في ((الخصائـص)) ]1/ [6 فقال: ((اعلم أن واضع اللغة لما أراد صَوْغَها، وترتيبَ أحوالِها، هَجَمَ بفكْره على جميعها، ورأى بِعَيْن تصوُّرِهِ وُجوهَ جَمْلِها وتفاصيلها، وعَلمَ أنَّهُ لابُدَّ من رَفْضِ ما شَنُع تألُّفه منها….. فنَفَاه عن نفسه، ولم يُمْرِرْهُ بشيء من لفظه…)).
وكان من مكمِّلات تصوُّرهم هذا، وجوُد موقفٍ موحَّد يَقِفُه جميع واضعي اللغة، حتى عبَّروا عن ذلك – كما صنع ابن جني – بلفظ الواحد: ((واضع اللغة))… ((وذلــك لأن العــربَ وإنْ كانــوا كثيراً مُنْتَشِريــن، وخَلْقـاً عظيمـاً فـــي أرض اللـــه غيـرَ مُتَحَجِّريـن ولا مُتَضَاغِطين، فإنهم بتجاوُرهم وتَلاَقيهم وتَزَاوُرهم يَجرونَ مَجرى الجماعة في دار واحدة…)). ]الخصائص: 2/[15.
وما كان لمثل هذه ((الجماعة اللغوية)) في نظرهم أن تَرْتَكِبَ خِلافَ الأوْلى.. ((وكيف كانوا يكونون في ذلك علـى ضعـفٍ مـن القيـاس والجماعةُ عليه؟! أفَتُجْمِعُ كافَّةُ اللغات على ضعف ونقص؟.. )). ]الخصائص: 2/15.
* * * *
ولكن علماء العربية لم يلبثوا أن تبيّنوا أن ((واضع اللغة)) لم يكن من البلادة بحيث يضع اللغة ويستريح، وإنما هو ((واضعٌ نشيط حَرِك))، لم يعجبه أن يجمُد على ما توصل إليه من بنيان، وإنما أخذ يُهَنْدِمُه من هنا ويُشَذِّبُهُ من هناك، حتى يبلغ به غايةَ الجمال. ولعل من أبرز ملامح هذه الظاهرة أي النحو باللغة منحى الجمال، ما يطلقون عليه طلب الخِفّة أو الاستخفاف، أو النأي عن الاستثقال. ومن ذلك قولُهم: ((واعلم أن التضعيف مستثقَل…. وقومٌ من العرب إذا وقع التضعيف أبدلوا.. )). ]المقتضب: 381/1
ومن أمثلة هذا العُدول عن الأصل لوجه الجمال أن الكوفيِّين أجازوا قلب الياء الأصلية واواً، فأجازوا في تصغير شيخٍ ((شُوَيْخاً)) كما أجازوا قلب الألف المنقلبة عن ياءٍ واواً، كما في نابٍ و((نُوَيْب)) واستدلّوا على ذلك بأنه سُمِع ((بُوَيْضة)) تصغيراً لبيضة. وقالوا كذلك ((عُوَيْنة)) في تصغير العين. ولاشك في أن الكوفيِّين قد جَنَحوا لذلك استخفافاً، لخفة النطق بالواو بعد الضمّة واستثقال النطق بالياء بعدها، إذ الضمة والواو أختان متجانستان، أما الضمة والياء فمتنافرتان·
ومن أمثلة ذلك أنهم (( أجازوا الحذف في بعض المواضع استخفافاً ))، وأنه (( إذا كان الحرف لا يَتَحَامَلُ بنفسه، حتى يدعو إلى اخترامه وحذفه، كان بأن يضعُفَ عن تحمُّل الحركة الزائدة عليه أحرَى وأحجَى. واستمرارُ ذلك – كما يقول ابن جني – أدلُّ على ذَوْقهم الحركات، واستثقالهم بعضَها واستخفافهم الآخر. وهكذا تبيّن لعلماء اللغة، أن ثـَمَّة نزوعاً دائماً إلى الخروج على الأصل ثم إلى الخروج عن القياس على الأصل، وتلك عملية طبيعية تزاولها الجماعة ويزاولها الأفراد، وتتجلى فيها حيوية اللغة.
وإنما يحدث ذلك بآلية يُطلق عليها الخليل وسيبويه اسـم ((التشبيه))، ويطلق عليها نحاةٌ آخرون اسم ((الحمل)). فكأن بنيان العربية نفسَه ليس ببنيان راكدٍ خامل، ولكنه بنيانٌ متفاعلٌ حَرك. ففيه مستويات مختلفة من التعبير، تَتَواثـَبُ بينها الكَلِمُ استجابةً لسَطْوَةِ الجمال أو سُلطان النَغَم، كتلك المستويات المختلفة من الطاقة في نواة الذرّة، تَتَواثـَبُ بينها الذُرَيْرات من جرَّاء سَطْوَةِ طاقةٍ خارجية ترتفع بها من مستوىً إلى آخر، كما أن فيه ساحاتٍ كحقول الجاذبية، تجذِب البـِنى المتشابهة بعضها إلى بعض. فهذا الذي أسلفناه يبيّن خروج الجماعة اللغوية على الأصل لِوَجْه الجمال.
ولكن الجماعة اللغوية تخرج على الأصل أيضاً لوجه الدقة العلمية. ((وذلك أن العرب كما تُعنَى بألفاظها فتُصلحها وتهذبــُها وتُراعيها وتلاحظ أحكامها، بالشعر تارةً، وبالخُطَبِ أخرى، وبالأسجاع التي تلتزمهـا وتتكلّف استمرارها، فإن المعانيَ أقوى عندهـا، وأكرمُ عليهـا، وأفخمُ قدْراً في نفوسهـا)). ]الخصائص: [215/1.
(( وسَبَبُ هذه الحُمُول والإضافات والإلحاقات كثرةُ هذه اللغة وسَعَتُها، وغَلَبَةُ حاجة أهلها إلى التصرُّف فيها، والتركُّح في أثنائها، لما يُلابسونه ويُكثرون استعماله من الكلام المنثور، والشعر الموزون، والخُطَب والسُّجوع، ولقوَّة إحساسهم في كلِّ شيء شيئاً، وتخيُّلهم ما لا يكادُ يشعر به من لم يألف مذهبَهم )).
****
ومما يغيَّر لوجه الجمال تارةً ولوجه الدقة العلمية تارات: باب النَّسَب.
- عن الأصمعي قال: ((والنَسَب في الناس إلى الحَرَم حِرْمي بكسر الحاء وسكون الراء، فإذا كان في غير الناس قالوا: ثوبٌ حَرَمي.. وذلك للفرق الذي يحافظون عليه كثيراً ويعتادونه في مثل هذا)).
- و عن ابن بري: ((المَرَئي منسوب إلى امرىء القيس على غير قياس، وكان قياسَه مَرْئي على وزن مَرْعيّ))، ولكنهم أخرجوه على هذا الوزن ليفرقوا بينه وبين ما يُرى.
- وفي (( المُمْتع)) للنهشلي القيرواني 140، 145: ((عن أبان بن ثعلب وكان عُرْبانياً عن عكرمة عن ابن عباس إلخ… قوله: ((عُرْبانياً)) فإن هذه الألف والنون تزادان في النسبة ليفرقوا بين العربيِّ اللهجة والعربيِّ النَسَب)).
- ويلخِّص ذلك ابن السِّيد في (( الاقتضاب )) [222] بقولـه ((المنسوب يَرِد خارجاً عن القياس كثيراً)). كما يقول المبرِّد في (( المقتضب )) [145/3]: ((واعلم أن أشياءَ قد نُسب إليها على غير القياس لِلَّبْس مرةً، وللاستثقال أخرى، وللعلاقة أخرى، والنَّسَبُ إليها على القياس هُوَ الباب)).
* * * *
خلاصة القول أن الجماعة اللغوية تخرج عن الأصل لوجه الجمال تارةً، ولوجه الدقة العلمية تارةً أخرى، أو قُلْ: عنايةً باللفظ خَطْرةً، ومراعاةً للمعنى خَطْرةً أخرى. حتى قال ابن السِّيد البطليوسي في (( الاقتضاب )) [281]: ((إن الأصول قد تُرْفَضُ حتى تصيرَ غيرَ مستعمَلة، وتُستعملُ الفروع)).
فأنتَ ترى قوَّة السلطان الجماعي في الخروج على الأصل، ومن أجل ذلك أزعم أننا بحاجة إلى مثل هذا السلطان في ما نحن بصدده.
* * * *
ما الذي يحدث الآن عندما يمارس الأفراد ما مارسته الجماعة؟
إن هذا هو الذي يطلقون عليه اسم ((الضرورة))، وهي تتجلى في اتجاهَيْن اثنَيْن: الاتّجاه الأول هو الخروج على الأصل اقتداءً بما فَعَلَتْهُ الجماعة اللغوية في بعض الأحوال، والاتّجاه الثاني هو العودة إلى الأصل ببعض ما أخرجته الجماعة اللغوية عن أصله.
يدلُّنا على الاتّجاه الأول بعضُ ما قال سيبـويه: في شبه قاعدة [12-11/1]: ((وليس شيءٌ يُضطرّون إليه إلا وهم يحاولون به وجهاً)).
أما الاتّجاه الثاني في مسيرة الضرورة، فهو اتّجاه معاكس لعملية الخروج الجماعية على الأصل: هو ردٌّ إلى الأصل أو إجراءٌ عليه، يصدر عمّا أودعه الله سبحانه في سليقة الشاعر من تــراث الجماعــة اللغويــة، فيجعله يعـود إلــى الأصل متهدّياً بهَدْي هذه السليقة. فمن كلام الخليل في ما يرويه سيبويــه [59/2]: ((كما قالوا حين اضطروا فــي الشعـر فأجروه على الأصـل)) ومـن كــلام سيبويـه [161/2]: ((واعلــم أن الشعــراء إذا اضطروا إلـى ما يجتمـع أهــل الحجاز وغيرُهم على إدغامه أجروه على الأصل….. وهذا في الشعر كثير)). ويقول المبرِّد في شبه قاعدة: ((الضرورة تَرُدُّ الأشياء إلى أصولها)) ]المقتضب: [354/3. وهو قد أمعن في ذلك حتى أجاز في الضرورة الرجوعَ إلى الأصل مطلقاً وإن لم يَرِدْ به سماع.
وفي ذلك يقول البغدادي في الخزانة: (( قد يكون للمعنى عبارتان أو أكثر، واحدةٌ يلزم فيها ضرورة، إلا أنها مطابقة لمقتضى الحال… ولاشك أنهم في هذه الحال يرجعون إلى الضَّرورة، لأن اعتناءهم بالمعاني أشدُّ من اعتنائهم بالألفاظ )).
وأنا أدعو إلى الاعتداد بهذيْن الاتجاهَيْن في ركوب الضرورة، فـي سبيل الحقيقـة والدقة العلمية، ولكنَّني أدعو – كذلك – إلـى أن تقــوم الجماعة اللغوية بذلك – وهي لجان توحيد المصطلحات ثم المجامع واتّحاد المجامع – فتستمدَّ الألفاظ المولَّدة على الضرورة من السلطان الجماعي قوةً كقوة الخارج على الأصل في ما أخرجته الجماعة اللغوية عن أصله حتى أصبح أرسخ من الأصل وأثبت.
وهذا أمرٌ طال ما اقترحته تسهيلاً لصَوْغ المصطلح العلمي. وقد سبق لي أن ذكرتُ أنه لابُدَّ لنا من إعداد ما أسميته ((مقدّمات منهجية وضع المصطلح العلمي وتوحيده))، وهي دلائل إرشادية ينبغي إعدادُها خيرَ إعداد، وجعلُها في متناول كلِّ مَنْ يريد مزاولة وضع المصطلح، ولاسيَّما الإعلاميِّين والتعليميِّين، لتكون دليلاً هادياً له في هذا السبيل، وقلتُ إنه لابُدّ من أن تضطلع بإعدادها سلطة لغوية جماعية كاتحاد المجامع، أو مجمع اللغة العربية بالقاهرة بتكليف من اتحاد المجامع.
* * * *
أسمح لنفسي بعد ما تقَدَّم أن أنتقل إلى (( المنهجية الموحدة )) على وجه الخصوص. ويخيَّلُ إليَّ أنني أستطيع أن أتحدث عن أمرين اثنَيْن: مقَدِّمات المنهجيَّة، والمنهجيَّة بالذات.
أما مقَدِّمات المنهجيَّة، فهي دلائلُ إرشاديَّةٌ ينبغي إعدادُها خيرَ إعداد، ووضعُها في متناوَل كُلِّ مَنْ يريد مزاولةَ وَضْع المصطلح، لتكون دليلاً هادياً له في هذا السبيل. ولابد من أن تضطلع بإعدادها سُلْطَةٌ لُغَويَّةٌ جَمَاعيَّة كاتحاد المجامع أو مجمع اللغة العربية بالقاهرة بتكليف من اتحاد المجامع.
وأهم هذه الدلائل الإرشادية في نظري ما يلي:
أولاً: قائمةٌ بالمبادئ اللغوية التي يُسترشَد بها بشكل عام. وقَدْ أقتَرِحُ لها مثلَ القائمة التالية:
- يقول أحمد بن فارس في (( الصاحبي )): (( أجْمَعَ أهلُ اللغة إلا مَنْ شذَّ عنهم، أنَّ لِلُغةِ العرب قياساً، وأنَّ العربَ تشتقُّ بعضَ الكلام من بعض )).
- يقول أبو عثمان المازني: (( ما قِيسَ على كلام العرب فَهُوَ من كلام العرب )).
- يقول ابنُ جني في (( الخصائص ))في فصل عنوانه (( قضية اختلاف اللغات وكلها حجة )): ((فالناطقُ على قياس لغةٍ من لغات العرب مصيبٌ غيرُ مخطئ، وإنْ كان غيرُ ما جاء به خيراً منه )). وينقلُ السيوطيُّ في (( الاقتراح )) قولَ أبي حيَّان في ((شرح التسهيل )): (( كُلُّ ما كان لغةً لقبيلةٍ قيسَ عليه )).
- يقول السيوطيُّ في (( الأشباه والنظائر )): (( علَّةُ الضرورة التشبيهُ لشيء بشيء أو الردُّ إلى الأصل )).
- يقولُ المبرِّد في (( المقتضب )): (( الضرورة تردُ الأشياء إلى أصولها )). وَهُوَ قَدْ أمْعَنَ في ذلك حتى أجازَ في الضرورة الرجوعَ إلى الأصل مطلقاً وإنْ لم يَرِدْ به سَمَاع. بَلْ بَلَغَ بذلك إلى أن يقول: (( قَدْ يجيء في الباب الحرفُ والحرفان على أصولهما وإن كان الاستعمالُ على غير ذلك، ليدُلَّ على أصل الباب )).
- يقول ابن جني في (( الخصائص )): (( اعلمْ أنَّ الشاعر إذا اضطُرَّ، جازَ له أن ينطق بما يبيحُه القياسُ وإن لم يَرِدْ به سَمَاع… فإنَّه إذا أدَّى القياسُ إلى شيءٍ ما، ثم نطقت العرب بخلافه، فإنَّ ما أدَّى إليه القياسُ ينبغي أن يُصرف على أنه لشاعر مولد أو لساجع أو لضرورة… هذا ما ذهب إليه النحويون )).
- يقول ابن سيده: (( قَدْ يُؤْثرون المحاكاةَ والمناسبةَ بين الألفاظ تاركينَ لطريق القياس))… إلى أن يقول: (( فإذا كانوا قَدْ يفعلون مثلَ ذلك محتشمينَ من كَسْر القياس، فأن يفعلوه فيما لا يكسر القياس أسْوَغ )).
- يقول ابن السِّيد البطليوسُّي في (( الاقتضاب )): (( المنسوبُ يَرِدُ خارجاً عن القياس كثيراً )). وذلك – كما يقول ابنُ منظور في (( اللسان ))-: (( للفرق الذي يحافظون عليه كثيراً ويعتادونه في مثل هذا )). ويرى ابن السِّيد (( أن العرب ربما حاكت المعنى باللفظ الذي هُوَ عبارةٌ عنه في بعض المواضع… ))إلى أن يقول: (( فزادوا في الألفاظ على ما كان ينبغي أن تكون عليه، كما زادت المعاني الواقعة على نظائرها )).
- يقول ابن جني: (( مِنَ التدريج في اللغة قولُهم دِيـمَة ودِيَم، واستمرارُ القلب في العين إلى الكسرة قبلها، ثم تجاوزوا ذلك لما كثر وشاع إلى أن قالوا: دوَّمت السماء وديَّمت. فأمَّا (( دوَّمت ))فعلى القياس، وأما (( ديَّمت )) فلاستمرار القلب في ديمة ودِيَم )).
- ينقل البغدادي في (( الخزانة ))ما ذكره البدرُ الدماميني في شرح التسهيل قوله: ((وتدوينُ الأحاديث – يعني أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام – والأخبار بل وكثيرٍ من المرويّات وقع في الصدر الأول قبل فساد اللغة العربية، حيثُ كان كلام أولئك المبدِّلين – على تقَدْير تبديلهم – يسوغُ الاحتجاجُ به، وغايتُهُ يومئذ تبديلُ لفظ بلفظ يصحُّ الاحتجاج به، فلا فرقَ بين الجميع في صحة الاستدلال، ثم دُوِّن ذلك المبدَّل – على تقَدْير التبديل – ومُنع من تغييرِه ونقلِه بالمعنى – كما قال ابن الصلاح – فبقيَ حُجَّةً في بابِه )).
- يقول ابن جني في (( المحتسب )): (( متى كان فعلٌ من الأفعال في معنى آخر، فكثيراً ما يُجرى أحدهما مُجرى صاحبه، فيُعدَل في الاستعمال به إليه، ويُحتذى في تصرفه حَذْوَ صاحبه، وإنْ كان طريقُ الاستعمال والعُرْف ضدَّ مأخذه! ))ويقول ابن هشام في (( المغني )): (( وقَدْ يُشربون لفظاً معنى لفظ آخر فيعطونه حكمه، ويُسَمُّون ذلك تضميناً )). وقَدْ قال جماعة من البصريين بقياسية التضمين على أنه ضربٌ من ضروب المجاز، والمجازُ قياس، وإذا كان التوسعُ في الفعل كان التضمينُ من قبيل المجاز الـمُرسل.
- يقول أبو هلال العسكري في (( التلخيص )): (( والكلمةُ الأعجميةُ إذا عُرِّبت فهي عربية! لأن العربيَّ إذا تكلّم بها معرَّبة لم يُقَلْ إنه يتكلم بالعجمية )).
- يقول المصطفى الشهابي في كتابـه عـن (( المصطلحات العلميـة )): (( لا ضيرَ في التعريب كلما مَسَّتِ الحاجةُ إليه، وكلما تعذَّرَ العُثورُ على كلمة عربية تقابل الكلمةَ الأجنبية، أو تعذَّر إيجادُ كلمة عربية تفيدُ معناها بوسائل الاشتقاق المعروفة )).. وأنا أضيف إلى ما قال: (( .. أو حين تكون الكلمةُ العربيةُ المقترحةُ أشدَّ عُجمةً من الكلمة الدخيلة، أو تكون اللفظة مما اشتهر وشاعَ استعماله، أو يكون اللفظ من الألفاظ التي اكتَسَبَتْ صفةَ العالمية بدخوله كما هُوَ في كُلِّ لغات العالم أو جُلِّها )).
- يقول ابن السيِّد في (( الاقتضاب )): (( ورأيتُ ابن جني قَدْ قال في بعض كلامه: الوجه عندي أن تُكْسَرَ الشينُ من شطرنج ليكون مثال جِرْدَحْل. وهذا لا وجهَ له، وإنما كان يجبُ ما قاله هنا، لو كانت العرب تصرف كُلَّ ما تعرِّبه من الألفاظ العجمية إلى أمثلة كلامها. وإذا وجدنا في ما عرَّبوه أشياءَ كثيرة مخالفة لأوزان كلامهم، فلا وَجْهَ لِهذا الذي ذكره )). على أن هذا لا يعني الترحيبَ بالإكثار من هذه الكلمات التي لا تُواكب أمثلةَ كلام العرب، بل العكسُ هُوَ الصحيح، لأن نقلها بهذه الأوزان الناشزة يجعلُ من العسير بل المتعذِّر جمعَها والنسبة إليها والاشتقاقَ منها.
- يقول الأستاذ الشيخ أحمد محمد شاكر في مقدمة كتاب (( المعرَّب ))للجواليقي: ((وأكثرُ الأعلام التي نَقَلَ العربُ وأوثقُها نقلاً ما جاءَ في القرآن الكريم من أسماء الأنبياء وغيرهم. فلو شئنا أن نُخرج منها معنىً واحداً تشترك كلُّها فيه بالاستقصاء التام والاستيعاب الكامل، وَجَدْنا فيها معنى لا يخرُجُ عنهُ اسمٌ منها وهو أن الأعلام الأجنبية تُنْقَلُ إلى العربية مغيَّرةً في الحروف والأوزان إلى حروف العرب وحدَها، وإلى أوزان كَلِمهم أو ما يقاربها، وأنها لا تُنْقَلُ أبداً كما ينطقُها أهلُها )).