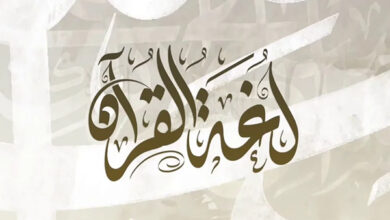أثر العولمة على المجتمع الإسلامي

العَوْلـَمَة ليست عفريتاً من الجنِّ أو مارداً خرج فجأة من القمقم، وليست خَلْقاً جديداً عجيبـاً لا عَهْدَ لنا به ولا قِبَل لنا به، ولكنها وَضْعٌ ألِفْناه منذ مولد حضارتنا وعشنا معه. فعَوْلَمَة القرن الحادي والعشرين هي امتدادٌ لعَوْلَمَات سابقة، أهمُّها عَوْلَمَة حضارتنا العربية الإسلامية.
صحيحٌ أنَّ العَوْلـَمَةَ اليوم قد تغيَّر اتجاهُها، فأصبحت متَّجهةً من الغرب إلى الشرق بعد أن كانت عَوْلـَمَةُ الأمس متَّجهةً من الجنوب إلى الشَّمال… وتغيَّرت مع تغيُّر الاتجاه منظومة القِيَم التي تنطلق منها المواقف. وصحيحٌ أنها قد تغيَّرت سرعتُها، فأصبحت اليومَ مندفعة بسرعة لا يكاد يلحق بها الخيال… ولكن تغيـيرَ الاتّجـاه أمـرٌ ينطلق مـن فِطْرة هـذا الكون: ]وتلـك الأيــام نداولـها بـين النــاس آل عمران: 14 و(( تغيـيرُ السرعة لا يغيِّر من طبيعة العملية أو من طبيعة الـحَدَث، ولكنه )) – كما يقول أخونا الدكتور مراد هوفمان – (( يجعلها مخيفة أكثر )).
فالسيارة التي تسير في العادة بسرعة أربعين ميلاً في الساعة، إذا ضاعفت سرعتها ثلاثة أضعاف أو أربعة، أصبحت مخيفة حقاً، وزادت حوادثها وصَدَمَاتُها، وزَلْزَلَتْ ما تصادفه في طريقها، ولكن ذلك كلَّه لا يغيِّر شيئاً من كونها سيّارة كسائر السيّارات. وأكثرُ ما يخيف الناس من العَوْلـَمَة، ما تفعله بثقافتهم. والثقافةُ هي تلك الأصول الثابتة التي تنغرس في نفس الإنسان منذ مولده ونشأته الأولى، وجِماعُها كلُّ ما يتلقَّاه عن أبويه وأهله وعشيرته ومعلِّميه ومؤدِّبيه. وثقافةُ الأمَّة، هي حصيلة ثقافات أبنائها، المثقَّفين بقَدْر مشترك. والحضارة هي المظهر المادي لهذه الثقافة. وهي نتيجة استعمال المثقّفين بثقافة معينة لمعطيات العلم والتكنولوجيا للارتقاء بالوضع المعاشي للإنسان.
والثقافة تختلف عن الحضارة بأنها تناقش وتحاور وتؤثـِّر، ولكنها تبقى متمسكة بذاتيّتها، أما الحضارة فتنزع إلى تعميم نفسها ما استطاعت. ولذلك رأينا الحضارات الكبرى تتجلى في شكل عوالم: العالم الروماني والعالم الصيني… والعالم الإسلامي. ولقد مارست الحضارة العربية الإسلامية على طريقتها ضرباً من (( العَوْلـَمَة )) – كما يقول الأستاذ جورج طرابيشي – إذ دَمَجَتْ بهـا ما لا يقل عن عَشْر من الثقافات الكبرى، هي: القبطية والبربرية والنوبية مغرباً، والسريانية واليونانية والفارسية والخراسانية مشرقاً، مع قطاعات من الثقافتين الهنديـة والصينية، فضلاً عن الثقافتين العربية المسيحية والعربية اليهودية اللتين عاشتا في كَنَفها، ولكنها استفادت من هذا الدمج بأنها اقتبست وتبنَّت كلّ ما هو نافع في جميع هذه الثقافات. فالثقافة إذَنْ تسعى إلى التفرُّد، والحضارة تسعى إلى توحيد الثقافات ودمجها. والعالم الحديث ينزع أكثر فأكثر إلى أن يكون موحّد الحضارة متعدّد الثقافات. وهذه الثقافات تُغني الحضارة الكبرى وترفدها بأصالاتها وخصوصياتها ولكنها تندمج بها في الوقت نفسه.
ويبدو أننا نميل إلى رفض كثير مما أنتجته الحضارة المعاصرة، لارتباطها في أذهاننا بالثقافة الأمريكية أو الغربية بوجه عام. وقد زاد من عدائنا للعَوْلـَمَة المنطلقة من الغرب، أن الأمر يتعدَّى عالمَ الأشياء، وهو عالم لا انتماءَ له في حقيقة الأمر، إلى عالمَ القِيَم. فالغربيون يؤمنون إيماناً لا يقبل المناقشة، بأنهم دائماً على صواب، وبأن المستوى الصَّوَابيَّ للقِيَم هو المستوى الذي حدّدوه هم. أما قِيَم الآخرين فإنهم يجهلونها أو يَزْدَرُونها، بل يحاولون أن يفرضوا قِيَمهم على الآخرين. ولكننا لا نستطيع أن نوقف مسيرة العَوْلَمَة، بل ليس من مصلحة الجنس البشري أن نفعل ذلك. فلها من الحسنات والمنافع ما يبشِّر بالتقدُّم والرخاء. والهجوم على الحضارة العالمية أو الانغلاق عليها، هو هجومٌ أو انغلاق على حضارة ورثت من الحضارة العربية الإسلامية الكثير. وإذا كنا نستنكر أو نضيق ذرعاً ببعض مساوئها، بل بكثير من مساوئها، فإن هذا لا يعني أن نتنكر لها ونحاربها وإنما ينبغي أن يدفعنا ذلك إلى إصلاحها من الداخل. فنحن لا نريد أن نعتنق ثقافة العَوْلَمَة الـمُعاصرة بخيرها وشرها وحلوها ومُرِّها وما يحمد منها وما يُعاب، بل نريد أن نرشِّد هذه المسيرة من الداخل، ولا نأخذ منها شيئاً إلا بعد عرضه على أسلوبنا في التفكير والنظر والاستدلال، فما استجاب له قَبَسناه، ولم نجد في ذلك أيَّ حرج، وما استعصى عليه سَعَيْنا جهدنا في تصحيحه وتقويمه، ولم نكتفِ بمجرد نبذه واطراحه. ومرشدنا في ذلك الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه عن النبي e: (( الكلمة الحكمة ضالّة المؤمن، أنـَّى وجدها فهو أحق الناس بها )). وما رواه ابن عبد البر عن سيدنا علي t: (( العلـم ضالّـة المؤمـن، فخذوه ولو من أيدي المشركين )).
ثم إننا لا نعادي الثقافات الأخرى، وإنما نناقشها ونجادلها ونحاورها. ولا يجوز لنا ونحن نشكو من الاستشراق أن نمارس استشراقاً معكوساً يفضي بنا إلى أن نخرج على حضارة العصر، ونخرج منها إما إلى اللاحضارة وإما إلى حضارتنا العربية الإسلامية القديمة التي مازالت – في رأيي – ماثلةً في حضارة العصر بما صَلَحَ أن يبقى منها في حضارة العصر. وسوف يكون موقفاً مشرِّفاً لنا، أن نضيف إلى هذه الحضارة العالمية ما ينقصها من روح وخُلُق ومُثُل وقِيَم. وأهم ما نستطيع أن نسهم به في تصحيح المسار، إضفاءُ مسحة أخلاقية على عولمة العصر. والموقف الأخلاقي عند المسلمين، ينطلـق من أن الـخَلْق كلهم إخوة، لأنهـم كما يسمِّيهـم القـرآن (( بنو آدم )). وهم يشتركون جميعاً في أن لهم رباً واحداً، وأنهم مهما اختلفوا فإن ربوبية الله تجمع بينهـم: (الله ربُّنــا وربُّكـم)الشورى: 15؛ (إلهنـا وإلهكم واحـد) العنكبـوت: 46؛ (الله يجمـع بينـنا) الشورى: 15؛ (( أيها الناس ! إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد )) رواه أحمد وأبو داوود عن زيد بن أرقم؛ (( أنا شهيد أن العباد كلَّهم إخوة )) رواه الإمام أحمد. وأنهم سواسية في التمتع بخيرات هذه الربوبية، لا تفرقة بينهم ولا تميـيز في أي أمر من الأمور التي تتعلق بربوبية الله عز وجل، كالماء والغذاء والرزق والعطاء والدواء والشفاء والإمداد بسائر أسبـاب الحيـاة: كـلاً نُمـد: هـؤلاء وهـؤلاء مـن عطـاء ربـك، (ومـا كـان عطـاء ربـك محظــوراً) الإسراء: 20.
لأن الإنسان مكرّم: (ولقد كرَّمنا بني آدم) الإسراء: 70؛ ويقتضي تكريمه هذا احترام شخصيَّته ومعتقداته وخصوصيَّاته، والمحافظة عليه في صحة تامة ومعافاة كاملة، وتوفير كلِّ مقوِّمات الحياة الكريمة له. ولأن الحياة حق لكل إنسان، وهي مقدَّسة محترمة مُدافَعٌ عنها. وقيمة النفس البشرية تعدل قيمة البشر جميعاً: (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً). والاعتداء على حياة أي نفس بشرية – أياً كان دينها أو جنسها أو لونها، ولو كانت جنيناً أو شيخاً أو معوقاً – اعتداء على البشر جميعاً: (من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً) المائدة: 32.
ولأن الله عزّ وجل قد استعمر الناس في الأرض ليعمروها ويستثمروا فيها وينمّوا خيراتها، ولكنه وضع لهم هذا الضابط (( بما ينفع الناس )) تحذيراً من الاستثمار في ما يضرُّ الناس. فأي استثمار من هذا القبيل ولو كان مصدراً لتنمية الثروة، هو في نظر الإسلام استثمار محرّم مجرّم. ومن أمثلته في عصرنا الاستثمار في التبغ والمسكرات والمخدِّرات، وكذلك كلُّ ما فيه استغلالٌ لا أخلاقي للبشر، فهذا كله من الإثم والباطل في نظر الإسلام. وقد صحَّ عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، أنه كان يسال الله علماً نافعاً، وأنه كان يستعيذ بالله من علم لا ينفع. وقد ضرب القرآن الكريم مثلاً للعلم الذي لا ينفع في قصة هاروت وماروت، وفي سورة الرعد: (ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لـَمَن اشتراه ما لَه في الآخرة من خلاق؛ ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون) البقرة: 102؛ (كذلك يضرب الله الحق والباطل: فأما الزَّبَـد فيذهب جُفـاء، وأمـا مـا ينـفع الناس فيمكث في الأرض) الرعد: 17.
والإسلام لا يكتفي بسلامة الغاية، وإنما تهمه سلامة الوسيلة على حدٍّ سواء، لأن الغاية في الإسلام لا تبرِّر الوسيلة بأي شكل من الأشكال. وإن من واجب المسلميـن في هذا العصر أن ينـادوا بهذه القِيَم. فالإنسـان لا تكتمل إنسانيتـه ولا تتجلَّى إنسانيته إلا بقِيَم. والقِيَم منبعُها الدين: (قُلْ إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم: ديناً قِيَماً) الأنعام: 161. والدين واحد: شرع لكم من الدين ما وصَّى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى) الشورى: 13.
ويا حبَّذا لو استطعنا إقناع العالم بالعودة إلى الاهتداء بمصادر الإشعاع هذه، وذكّرنا العالمين بأن الـعَوْلَمَة الكبرى السابقة على هذه الـعَوْلَمَة، قد طبَّقت هذه القِيَم على صعيد الواقع.. وأن الحضارة الإسلامية لم تكن تعني حضارة المسلمين وحدهم، ولكنها حضارة شارك في إغنائها ورفدها كلُّ من عاش في تلك الرقعة الفسيحة من الأرض، الممتدة على قارات ثلاث.. ممن كانت تحكم حياتَهم وسلوكهم قِيَم ودين!