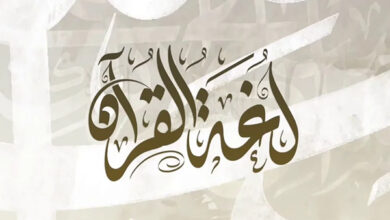التـرجمة النفيسة للقرآن المجيد

أكاد لا أستطيع أن أجد الكلمات التي أعبّر بها عن سعادتي بصدور هذه التـرجمة النفيسة للقرآن المجيد. وهي ترجمة طالَ ما انتظرناها لنَضَعَ بين يدي القارئ الأعجمي صورةً أقربَ ما تكون مطابقةً للذِّكْر الحكيم.
(( ومعلومٌ – كما يقول شيخ الإسلام ابن تيميَّة – أن الأمَّة مأمورةٌ بتبليغ القرآن: لفظه ومعناه، كما أُمر بذلك الرسول، ولا يكون تبليغ رسالة الله إلا كذلك، وأن تبليغه إلى العجم قد يحتاج إلى ترجمة لهم، فيُتَرْجَمُ لهم بحسَب الإمكان، والتـرجمة قد تحتاج إلى ضرب أمثال لتصوير المعاني فيكون ذلك من تمام التـرجمة )). دقائق التفسير: 1/166.
فالنهوضُ بهذا الواجب فرضُ كفاية، اضطلع به أخي الحبيب الأستاذ الجليل الدكتور أحمد زكي حمـّاد، على مدى نَيِّف وربع قرن، باذلاً قُصارَى جهده في نقل معاني آيات الكتاب المبين نقلاً أميناً يُحَقِّقُ غايَتَهُ في تبليغ القرآن.
وهذا النقل الدقيقُ الأمينُ عملٌ جليل، لا يعرفه إلا من دُفِعَ إلى مَضَايِق التـرجمة، كتلك الـمَضَايق التي تحدَّث عنها طَرَفَةُ بن العَبْد في وصف القَوَافي:
رأيت القوافي يَتَّلِجْنَ مَوَالِجاً تَضَايَقُ عنها أن تَوَلَّجَها الإبَرْ !
أو تلك التي قال عنها البُحْتُرِيُّ لعُبَيْد الله بن طاهر: (( … وإنما يعرف الشِّعْر من دُفِعَ إلى مَضَايِقِه! )).
وقد نَبََّهَ على ذلك الجاحظ في كتاب (( الحيوان )) بقوله: (( ثم قال بعض من ينصُر الشعرَ ويَحُوطُهُ ويحتَجُّ له: إن التـرجمان لا يؤدي أبداً ما قال الحكيم، على خصائص معانيه، وحقائق مذاهبه، ودقائق اختصاراته، وخفيَّات حدوده، ولا يقدر أن يوفّيها حقوقها، ويؤدي الأمانة فيها، ويقوم بما يلزم الوكيل ويجب على الجَرِيّ؛ وكيف يقدر على أدائها وتسليم معانيها، والإخبار عنها على حقِّها وصدقها، إلا أن يكون في العلم بمعانيها، واستعمال تصاريف ألفاظها، وتأويلات مخارجها، مثلَ مؤلف الكتاب وواضعه؟ )).
ثم قال: (( ولابدَّ للتـرجمان من أن يكون بيانُه في نفس التـرجمة، في وزن علمه في نفس المعرفة؛ وينبغي أن يكون أعلم الناس باللغة المنقولة والمنقول إليها، حتى يكون فيهما سواءً وغاية. لأن كُلَّ واحدة من اللغتَيْن تجذب الأخرى وتأخذ منها … وكيف يكون تمكُّن اللسان منهما مجتمعتَيْن فيه كتمكُّنه إذا انفرد بالواحدة؟ … وكلما كان الباب من العلم أعسر وأضيق، والعلماء به أقل، كان أشدَّ على المتـرجم ..)).
فكيف إذا كان الكلامُ الذي يُنْقَلُ كلامَ ربِّ العالمين؟
وإذا كان شيخ الإسلام ابنُ تيميَّة [في دقائق التفسير] قد جعل (( التـرجمة والتفسير ثلاثَ طبقات؛ إحداها: ترجمة مجرَّد اللفظ، مثل نقل اللفظ بلفظ مرادف. ففي هذه التـرجمة تريد أن تعرف أن الذي يُعنَى بهذا اللفظ عند هؤلاء، هو بعينه الذي يُعنَى باللفظ عند أولئك. و[الطبقة] الثانية: تـرجمةُ المعنى وبيانُه، بأن يصوَّر المعنى للمخاطَب، فتصوير المعنى لـه وتفهيمه إياه قَدْرٌ زائدٌ على ترجمة اللفظ …. إذْ هو تركيبُ صفاتٍ من مفردات يفهمها المخاطَب، لكون ذلك المركَّب صَوَّر ذلك المعنى، إما تحديداً أو إما تقريباً. والدرجة الثالثة بيانُ صحة ذلك وتحقيقه بذكر الدليل والقياس الذي يحقق ذلك ….))، فإن عالِمَنا الجليل قد أخذ من كلٍّ من الدرجتين الأولَيَيْن بسبب، ولجأ إلى الدرجة الثالثة إذا اقتضى الأمر، مُتَهَدِّياً في ذلك بما خَبَرَه طَوَالَ إقامته في بلاد الغرب، من مقدرة الأعاجم على تفهُّم الكتاب العزيز والتفاعُل معه.
وليس يخفىَ أن القرآن الحكيم قد نَزَل بلسان الرسول الذي كان يتحدث به، فقد قال U عن كتابه مخاطِباً نبيَّه: (فإنَّما يَسَّرْناهُ بلسانِك) سورة مريم: 97، كما قال: (وما أرسَلْنا من رسولٍ إلا بلسان قومه ليُبيِّن لهم) سورة إبراهيم: 4، أي بِلُغة العرب الـمُتَدَاوَلَة وقت نزول القرآن، وهي لغة مُضَر، أي لغة قريش ومَنْ جاورها من العرب؛ كما قال سيدنا أمير المؤمنين عثمان لكُتَّاب القرآن من المهاجرين: (( فاكتبوه بلُغة قريش، فإن القرآن نَزَل بلُغتهم )) ]رواه البخاري عن أنس[، ولذلك قال العلاّمة ابن خلدون: (( وإنما وقعـت العناية بلسان مُضَر … وكان القرآنُ مُنَزَّلاً به، والحديثُ النبوي منقولاً بلُغته )) ]المقدمة: ص 634.
والمؤسف أن عامَّة الناس، بل حتى فقهاءَهم ومفسِّريهم، قد ابتعدوا بمعاني كثير من الكلمات عن المعاني التي كانت لها يوم نزل بها الوحي، ثم أخذوا يَلْوُون أعناق النصوص القرآنية والنبوية لتتَّفق مع مصطلحات العصر الذي يعيشون فيه. وهو ما لفت النظر إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ]في الرسائل والفتاوى: 3/101[: (( ومن أعظم أسباب الغَلَط في فهم كلام الله ورسوله، أن ينشأ الرجل على اصطلاح حادث، فيريد أن يفسِّر كلام الله بذلك الاصطلاح ويحمله على تلك اللغة التي اعتادها )). ومن قَبْلُ قال أبو عَمْرو بن العلاء ]المتوفَّى سنة 154هـ[، وهو من أعلم الناس بلسان العرب وكلامها وأساليبها: (( اللسانُ الذي نَزَلَ به القرآن وتكلَّمت به العرب على عهد النبي e، عربيةٌ أخرى غيرُ كلامنا هذا! )).
ولذلك كان لابُدَّ من العودة إلى المعاني الأصيلة لهذه الألفاظ، حتى نفهم القرآن حقَّ فهمه ونتلوَه حقَّ تلاوته.
وأشهد لقد كان الأخ الكريم يبذل قصارى جهده في العودة إلى هذه المعاني الأصيلة، على ما في ذلك من عَنَت، وأشهد أنه أوَّاب إلى الحق سَرْعانَ ما يُبادر إلى تصحيح أيِّ لفظة أو عبارة يتبيَّن له أنها لم تُطابق الكلام القديم. فهنيئاً لهذا العالم الجليل ولـمَنْ شَرُف بالعمل في ركابه بإصدار هذا السِّفر العظيم.
وهنيئاً لنا – أبناءَ هذا الجيل – أن نشهد مثل هذه التـرجمة النفيسة، التي تَصِلُ عبادُ الله – من غير الناطقين بالعربية – بكتابه الـمُنير، وتُيَسِّر علينا الاستشهاد بآي الذكر الحكيم في أحاديثنا وكتاباتنا ومُحَاوراتنا كلَّما أردنا ذلك.
وإني لأضَرْعُ إلى الله أن يتقبَّل هذا العمل، وأن يجعله عنده زُلْفَى يوم تَزِلُّ الأقدام، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك!
ربَّنا آمنَّا بما أنْزَلْتَ واتَّبَعْنا الرَّسُولَ فاكتُبْنا مع الشاهدين.
22 ربيع الأول 1427